في العبودية الثقافية
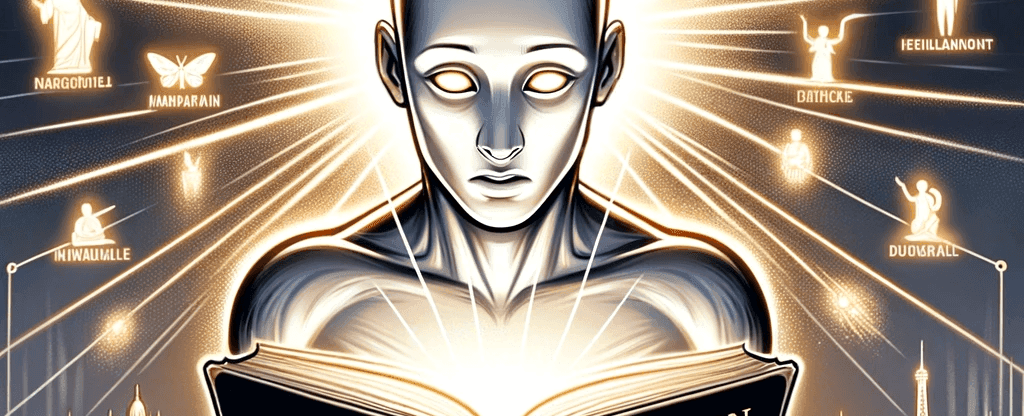
يُتوقّع مِن دعاة التفكيكية النقدية الترحيب بكل ناقد، والإفساحُ لأي تفكيك أو تفكير. لكنّ رداتِ الأفعال على مقالي الأخير عن ميشيل فوكو تذكرنا بأنّ المُتاح غيرُ المُرام، وأنّ الموجود غير المنشود. فما إنْ كتبتُ تعليقاً على البوائق التي نشرتها التايمز البريطانية عن فوكو حتى ورِمَتْ له أنوفٌ، وتلمَّظتْ شفاه، وانعقدتْ أيدٍ للَّكم والضرب.
غضب الفوكويون لأنّي قرأتُ سلوك الشيخ اتكاءً على مشروعه الفكري، أو رددتُ فكرَه إلى سلوكه ونوازعه النفسية. وما كنتُ إخال أحداً سيغضب لأنّي قمت بما نصح به هو في أحاديثه وكتاباته كما بيّنت. وهذه وقفة للتنبيه على عدة أمور حتى لا يطير القومُ بحواشي كلامي، أو يقوّلوني ما لم أقل.
العلاقة الواعية
أنا لم أدعُ إلى رمي كتب فوكو في البحر، وعدم تدريس نصوصه في النقد الثقافي. كلّ ما دعوتُ إليه هو العلاقة الواعية بمشروعه. فقد أُدخل فوكو إلى ساحتنا إدخالاً احتفالياً، محمولاً على أعناق المريدين ذوي العيون الجاحظة، والأصواتِ العالية انبهاراً. فما تبيّن الناس فكرَه ولا درسوه دراسة متأنية (حسب الفيلسوف أبي يعرب المرزوقي) بسبب الصخب الشعائري الذي رافق قدومه. فكثير مِن الدارسين العرب لم يفهموا مشروعه بل وقعوا تحت تأثير الإعلام الإيديولوجي الصاخب فحسب.
وقد حان الوقت لدراسة الرّجل وبناء علاقةٍ واعية بتراثه. فمِن احتقار العقل أن تربط أجيالٌ علاقتها بشخصية مثل فوكو دون أن تعي طبيعة مشروعه الفكري، والبنيةَ النفسية لمؤلفه، والسياقَ الفرنسي-الغربي الذي وُلد فيه.
فالقراءة الواعية له ينبغي أن تستحضر أمراضه وانشغالاتِه، والأفكارَ العميقة المحرّكة لتفكيره كما اتضحت في سلوكه وعلاقاته السادية (sado-masochism) وأمنياته واعترافاته. ويمكن رصد كل ذلك من كتابات عشيقههرفي غيربت،ومن سيرته بقلم جيميس ميلر.
القداسة المادية
لقد قُدّم فوكو وأضرابُه إلى الحلبة الفكرية باعتبارهم تنويريين تتأسس أفكارهم على النقد المفتوح، والحديث عن المُوارى والمحرّم. وتقوم محكيّاتهم على الحديث عن التابو والمسكوت عنه، مع سقوفٍ مفتوحة تحتقر المقدسات، وتضيق بالحدود والسدود. غير أنّ أنصار الرجل أثبتوا تهافت هذه الدعوى.
فمريدوه يقعون في معضلة منطقية حين ينقدون التقديس ثم يقدّسون شيوخهم. فهم يقدّمون رموزهم ضمن محكيّة ليبرالية مادية مؤسسة على العقل والنقد. لكنّك ما إنْ تقترب من تلك الرموز نقداً حتى تجدهم يعاملونها معاملة الأنبياء، وما إن تفتح فمك ضد أي رمز من رموزهم حتى يصرخوا ألماً كأنك وطئتَ أقدامهم بعجلة حافلة متأنية.
وأنا لا أمانع من معاملة شخص فوكو معاملة المقدّس شريطة أن يملك مريدوه الشجاعة الفكرية للاعتراف بتقديسه. فأنا أنطلق من فكرة إسلامية تلزمني باحترام كل مقدّس أمام أتباعه مهما كانت ماديته وتهافته.
فقد نهى القر�آن عن سبِّ أيّ آلهة فقال: “وَلَا تَسَبُّوا الّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُّبّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ” (الأنعام). لكنّ القوم يقدسون شيوخهم فعلاً وينكرون ذلك قولاً، ثم يدعونك لعدم تقديس أيّ كان. فإذا عبّر طالب في فصل عن احتقاره لفوكو طُرد من الجامعة أو أُفشل في الامتحان مهما كان نبوغه. ما معنى هذا؟ أليس هذا هو التقديس وإلغاء العقل والتعصب الأعمى؟
بين تعصّبيْن
الحقيقة أنّ لكل فرد مقدساته، اعترف بذلك أم لم يعترف. فتلك طبيعة الإنسان. غير أن ثمّة فرقاً بين تقديس الماديين لرموزهم وتقديس المؤمنين لرموزهم. فالتقديس المادي تقديس مفتوح لا سماء له لافتقاده المرجعية المغروسة في المطلق.
فهو تقديس مفتوح لا تحدّه إلا نزواتُ صاحبه، ولا يُلجمه أيّ رادع. تقديسٌ لا مكابح له، ولا مداخل لتخفيف غلوائه. لأنه تقديس مادي مرجعيته طينية متصلبة شهباء. فيستطيع صاحبه تبرير كل فعل، ويرتكب كل فظيعة. ولذا، فالتعصب العلماني أخطر آلاف المرات من غيره من التعصب الديني، ونتائج الحروب التي شنها الملاحدة من موسوليني إلى لينين، إلى هتلر، إلى الاستعماريين الفرنسيين، تصرخ بذلك.
ويتضاعف الفرق بين التعصبيْن في منطقتنا الإسلامية. فالتعصّب الديني مزمومٌ بق�يمٍ دينية وخُلقية متجاوزة لا يستطيع المؤمن التجرّؤ عليها غالباً، والتعصبُ المادي غير محكوم إلا بالأمزجة السوداوية والنفوس المعتمة، والنفسيات العجيبة التي تشكلت على التعقد من المجتمع الذي يخالفها في المرجعية والتوجه والذوق.
وعليه فالأستاذ الفوكوي الذي دمّر مستقبل طالبٍ تونسي لأنه نقدَ فوكو أو احتقره لن يتقلب في مضجعه ليلاً خوفا من عاقبة الظلم. أما المتدين الظالم فقد يفعل الفعلة الشنعاء لكنّه قد يعود عنها، وقد تهزّه الضحية مذكرة إيّاه بربّه، وقد يسمع موعظة عابرة ترده عن غيّه. فثمة مداخل كثيرة إلى قلبه وعقله. وهنا مَكمن الفرق ما بين التعصّب المادي والديني.
العبودية الثقافية
تعاني مجتمعاتنا من أمراض نفسية أبرزها مرض العبودية الثقافية. وهو داء ناشئ عن الهزائم العسكرية والثقافية التي مُنيت بها منذ قرون. ومن مظاهر هذا الداء احتقار المرء لذاته وعقله وبيئته ونفسه، تجسّداً للفكرة الخلدونية عن ولع المغلوب بتقليد غالبه. ولعل كثيراً من الأصنام الفكرية التي يحرم الحديث عنها سلباً، مثل فوكو، إنّما تصنّمتْ بسبب تلك العبودية الثقافية.
ومن الطرائف التي لا تخطئها العين أنّ العبد الثقافي في المغرب العربي إذا جاء ينطق اسم فوكو يغير جِلسته ويمدّ رقبته متخذاً وضعية الاستعداد الخاشع. ثم يُدوّر شفتيه عند خروج المقطع الأول “فو”، ثم يفتحهما منفرجتيْن قليلاً عند ارتطام مؤخرة لسانه بجدار حلقه، ثم تعتريه هزة ونشوة. فيظنّ المنصتُ إليه أنه أتى بالأوابد، وأعاد الضائع، وفتح المنغلق وحرر الأوطان السليبة. ولا يكتفي بذلك الطقس فحسب، بل يتوقّع منك أن تسلّم الفكرة التي قال مهما كان تهافتها وتناقضها المنطقي لأنه عوّذها باسم فوكو الأعظم.
الحقيقة التي يلاحظها كلّ عاقل غير مخدوع عن عقله أنّ لكلّ إنسان مقدساته كما أسلفت. فنحن، معاشر المسلمين، نُسْتنفَز عند نطق اسم مُحمّد صلّى الله عليه وسلم. فنصلّي عليه تعظيماً. لكنّنا مقرّون بذلك غير مخادعين فيه. أما هؤلاء فيُصلّون ويسبحون بطريقتهم ومصطلحاتهم ثم يكتمون عنك ذلك ويغلّفونه بمحكيّات شتّى.
ولعل من الأدلة الكاشفة عن المنهج التقديسي لفوكو عند هؤلاء قضية قصته مع الصهيونية. فهم يقدّمونه على أنّه معارض للاستعمار. لكنّهم يكتمون عن الناس وعن أنفسهم وقوفه مع إسرائيل وتصريحه أنّه ما خرج من تونس إلا لانزعاجه من مظاهرات الطلاب المعارضة للصهيونية. بل يحكي إدوارد سعيد في مقاله بمجلة (لندن رفيو أوف بوكس، 1 يونيو/حزيران، 2000) أنّه عندما زاره في بيته هرب منه وظلّ يتسكّع في باريس خوفاً من أن يُثير معه الملف الفلسطيني.
كما لاحظ الأستاذ الزواوي بغورة أنّه كان يتذرّع بالغياب أبداً كلّما طولب بموقف أخلاقي في أي لحظة مرتبطة بقضية الجزائر أو فلسطين (الزواوي بغورة، مشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر، 9).
ومِن الدّال على أنّ إدوارد سعيد يذكر في مقاله الآنف أن من أسباب خروج فوكو من تونس انكشاف تحرّشاته بصغار الطلبة الجامعيين. لكنّ الغريب ما انتبه له الأستاذ مالك التريكي مِن أن صحيفة “لوموند” الفرنسية أعادت نشر مقال سعيد (يوم 15 سبتمبر/أيلول، 2000) لكنها حذفتْ الفقرةَ المتعلقة بخروجه من تونس لتحرشه بالطلاب. أهذا كلامٌ عن الموارى والمحرّم؟ أم هو تقديس ديني جاف لفوكو؟
بين المؤلف ونصوصه
ثمّة طرق متعددة في قراءة النصوص بعضها تأويلي مُنصبٌّ على النص، وبعضها مهتم بالكاتب وبيئته ونفسيته. لكنّ المنهج الإسلامي يضيف لها بُعداً ثالثاً. فالمسلمون اهتموا بنقد النصوص وتأويلها (دراسة المتن) واعتنوا كذلك بدراسة المؤلف مِن خلال موضوع السّند. ثم أضافوا بُعداً ثالثاً وهو البُعد الأخلاقي والإيديولوجي في شخصية الراوي/المتكلم (العدالة).
وهو منهج أقرب ما يكون للمنهج الإنساني الواعي والجامع بين الأبعاد المؤثرة في الإنتاج المعرفي البشري.
بقي أن أشير إلى أنّ �بعض الذين فزعوا لفوكو أشاروا إلى كون كاتب هذه الأحرف غير متخصّص في فوكو، ولذا لا يحقّ له الحديث عنه. وهذا يؤكّد ما ذكرناه أعلاه أنّ القوم حوّلوا شخصياتهم إلى شخصيات متعالية لا يجوز الحديث عنها إلا لكرادلةٍ محصورين مؤتمين على تأويلها.
وهم يتسوّرون على ابن تيمية والشافعي ومالك، ويكتبون عن الجوانب الشخصية لهؤلاء العظماء ويؤولون تصرفاتهم كيف شاؤوا. لكنّك إذا اقتربتَ من الحديث عن عاهاتهم تلبّد الجو وعلت الأصوات واحمرّت الحِدَقُ… وتحركت أكفٌّ للضرب.

